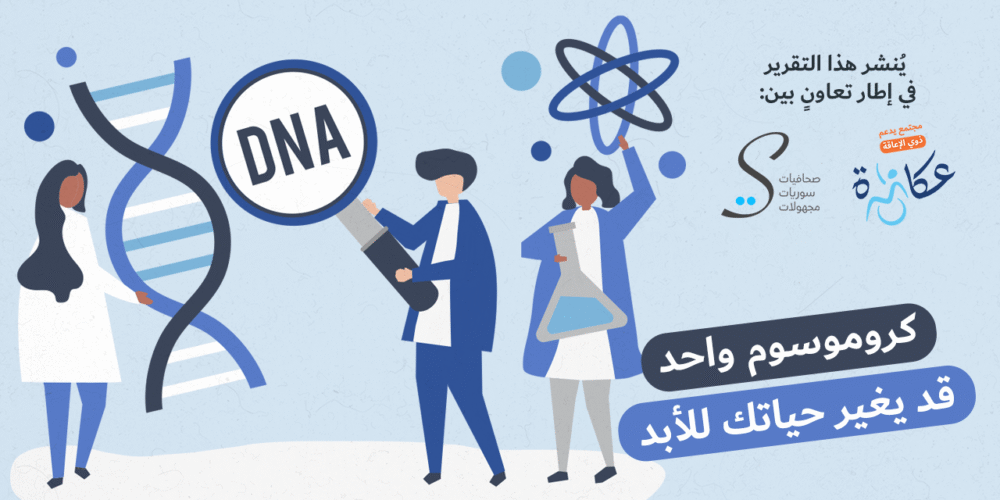سلكت ‘أم ألمى’ طريقاً شاقاً لإثبات حق ابنتها في التعليم ضمن المدارس الحكومية، مؤكدة أن إصابة ألمى بمتلازمة داون لا ينبغي أن تكون سبباً لحرمانها من هذا الحق، أسوةً ببقية الأطفال. استغرقت رحلتها عامين كاملين واجهت خلالهما عراقيل إدارية وطبية واجتماعية عديدة. كما خضعت الطفلة لسلسلة من الفحوصات والاختبارات أمام لجان وزارة التربية وجمعية الرازي ومراكز طبية متعددة. فضلا عن اضطرار ألمى للانقطاع عن الدراسة عاماً كاملاً لإعادة القييم النفسي والتربوي.
متلازمة داون هي حالة وراثية تنجم عن وجود نسخة إضافية كاملة أو جزئية من الكروموسوم 21. يُعرف هذا التغيير البسيط في التركيب الجيني للجسم بـ «التثلث الصبغي»، وهو المسؤول عن الخصائص الجسدية والنمائية المميزة للمصابين بالمتلازمة. الكروموسوم الزائد، رغم صغره، يرسم حياة مختلفة مليئة بالتحديات، ويضع الأسر أمام مسار طويل من السعي نحو الاعتراف والتمكين، والدمج في المجتمع.
صك الدمج انتصار أم بداية معركة
يبدو القرار الصادر في سوريا لدمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم في مرحلة التعليم الأساسي، وفق المادة الخامسة من القانون رقم 19 للعام 2024، أشبه بشعارٍ رنّان كان يردّده المسؤولون سابقاً عن «حقوق الطفل»، لأن الواقع يضرب عرض الحائط بكل التصريحات البرّاقة حول التسهيلات المرافقة لهذا القرار.
إذ بلغت تكلفة مركز التأهيل لطفلة في الثامنة من عمرها نحو أربعة ملايين ونصف المليون ليرة سورية (ما يعادل 300 دولار أمريكي وقتها)، تكبّدتها أم مطلّقة نتيجة إنجابها ابنة مصابة بمتلازمة داون، ولأبٍ غير متفهّم أن مرض ابنته ليس جريرة يد، ولا فعلاً مشيناً جلبته الأم لأسرتها.
ومع ذلك، لم تستسلم الأم واستطاعت أخيراً انتزاع «صك الدمج» بعد إنتهاء الفحوصات وإعادة التقييم من جديد، لتصبح ألمى، التي أتمّت عامها العاشر، تلميذة في الصف الثاني الابتدائي في مدرسة حكومية بمدينة التل (ريف دمشق).
لكن من يدري، هل ستُكمل الفتاة رحلتها التعليمية مع أساتذة مختصين بحالتها الصحية في مدرستها العامة؟ أم سيكون العبء الأكبر على والدتها، كما هو الحال الآن؟ وهل سيكون طريقها الأكاديمي واعداً، أم أنها ستخوض معركة أكثر صعوبة لتأمين مكان لها في سوق العمل؟
احتضنوه صغيراً وتخلوا عنه كبيراً
لم يُكتب لـ ‘حمزة’ الدخول إلى مدرسة عامة، بل تابع مسيرته التعليمية من خلال زيارة عدة مراكز موزّعة على جغرافيا دمشق، انطلاقاً من جمعية الرجاء في منطقة القنوات، مروراً بجمعية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي في منطقة حاميش، إلى مركز أنمار في منطقة التل.
قدمت هذه الجهات جلسات علاج نُطق ودعم نفسي، وبعضها علّمه مهارات يدوية، ليصبح حمزة اليوم شاباً في الخامسة والعشرين من عمره، بعمرٍ عقلي يعادل عشر سنوات، يملك من الاستقلالية ما يمكّنه من الاهتمام بشؤونه بمفرده، والذهاب إلى نادي الكاراتيه وممارسة الرياضة التي يحبها.
تقول والدته ‘أم محمود’ وهي أم لأربعة أبناء: “ابني ودود ومحبوب بين أفراد مجتمعه، جميع أصدقائه من غير المصابين بمتلازمة داون. وكان يساعد والده -رحمه الله- في شراء احتياجات المنزل.”
ورغم حبّه لترتيب الملابس وشغفه بالتنظيم، فالواقع لا يتيح لحمزة فرصة عمل آمنة أو بيئة إنتاجية تناسب قدراته. تضيف والدته بأسى: “أحلم باستقلالية ابني المادية ليكون فرداً منتجاً في مجتمعه، فمهاراته التعليمية التي اكتسبها على مرّ السنين، والتي تعبنا كثيراً حتى حصل عليها، بدأت بالتراجع بسبب غياب المتابعة؛ المراكز الحالية تستقبل الأطفال فقط، أما الشباب فلا مكان لهم، ويُتركون لمصير مجهول”.
حلم صعب المنال في بيئة معيقة
تحلم ‘دعاء’ الشابة الثلاثينية، بإكمال دراستها ودخول الجامعة، بعد أن تميّزت منذ طفولتها عن أقرانها من أصحاب متلازمة داون، وحققت المركز الأول في أولمبياد النطق في محافظة القنيطرة، لكن الحرب سرقت منها سنوات حاسمة.
اليوم، تفكر دعاء بالعودة إلى الدراسة من جديد، مستفيدة من البرامج التدريبية في جمعية “شباب المستقبل” في شارع بغداد، حيث تنمّي مهاراتها الفكرية والمهنية، بمرافقة دائمة من والدتها لحمايتها من أي أذى محتمل.
تروي الأم أنها تترك لابنتها حرية التصرف مع الأشخاص من حولها، لكنها لا تسمح لها بالخروج من المنزل بمفردها، بل يرافقها دائماً أحد أفراد العائلة، خوفاً عليها من أي تنمّر أو تحرش قد تتعرض له. فالحفاظ على سلامة دعاء النفسية والجسدية يُعدّ أولوية قصوى بالنسبة للعائلة. تُضيف الوالدة: “لا يمتلك أفراد المجتمع الوعي الكافي بخصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فهم معرّضون للأذى في أي لحظة، وأنا لن أضع ابنتي في هذه الدائرة”.
تشكل هذه المخاوف عبئاً إضافياً على الأسر ، وتطرح سؤالاً مشروعاً حول كيفية تمكين هؤلاء الشبان والشابات ليستطيعوا مواصلة حياتهم المهنية والتعليمية في بيئة غير آمنة؟
بذرة أمل تحتاج لاهتمام
يُستشهد بمطعم “سوسيت” الكائن في حديقة تشرين وسط العاصمة دمشق، بوصفه نموذجاً فعّالاً لدمج المصابين بمتلازمة داون في سوق العمل، يجمع طاقمة بين أشخاص من ذوي الإعاقة وآخرين غير مصابين، يعملون معاً على خدمة الزبائن.
تشير ‘رُهيفا سعدو رجب’ مديرة الشؤون الإدارية في جمعية “جذور التنموية” التي تقف خلف المبادرة، إلى أن الهدف الرئيسي هو استقبال الطفل وتأهيله وتدريبه وفق مقدراته، ليتوجه بعدها للتعليم أو للتدريب المهني. وتؤكد أنه كلما كان عمر المستفيد أصغر، زادت فرص تحقيق نتائج إيجابية. ومع ذلك، ترى رجب أن العبء الأكبر يقع على كاهل الأسرة لضمان الاستمرارية ومنع حدوث انتكاسات.
وتتابع: “مطعم سوسيت يُعدّ نموذجاً ناجحاً لدمج أشخاص تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل جيد للقيام بمهامهم، وهو أيضاً مصدر دخل جيد لهم ولعائلاتهم. غير أن المشروع لا يزال مبادرة فردية ولا تكفي وحدها لسد الفجوة”.
تجاوز عدد المستفيدين من برامج الجمعية نحو 200 شخص حتى تاريخه، يعيشون في بيئة حاضنة تتيح لهم تعلّم مهارات يدوية، وصناعة الشموع والحلويات، والمشاركة في البازارات الخيرية لتأمين دخل بسيط لهم كأفراد منتجين في مجتمعهم.
لا بديل عن خطة وطنية شاملة
رغم وجود بعض المبادرات المتفرقة لتوظيف شبّان من أصحاب متلازمة داون، مثل شاب يعمل في محل لبيع الكعك، وآخر في قصّ تذاكر الباصات، وغيرهم في محال الألبسة، إلا أنها تبقى محاولات خجولة واستثناءات لا تُعالج المشكلة البنيوية في بيئة تفتقر إلى إحصائيات دقيقة عن أعداد المصابين، أو إلى برامج ممنهجة لتأهيلهم ودمجهم مهنياً.
ومع غياب الإحصاءات الرسمية، تشير تقارير إعلامية إلى أن شمال غرب سوريا وحدها تضم أكثر من 800 مصاب بمتلازمة داون. فيما تُقدر الأمم المتحدة أن متلازمة داون تصيب طفلاً واحداً من بين كل ألف ولادة حيّة على مستوى العالم. ويُولد سنوياً ما بين 3 إلى 5 آلاف طفل يعانون من هذا الاضطراب الجيني.
وما يحتاجه هؤلاء، كما تؤكد رجب، ليس مبادرات عاطفية فحسب، بل خطة وطنية شاملة تبدأ بدمجهم في المؤسسات التعليمية، وتهيئة المدارس العامة لاستقبالهم، مع تدريب الكوادر التربوية على التعامل معهم، وصولاً إلى توفير فضاءات ترفيهية آمنة، ودعم الجهات القائمة على رعايتهم.
كما تُشدّد على أهمية إطلاق برنامج إعلامي توعوي يرسّخ ثقافة احترام التنوع، ويعزز مفهوم الدمج، ويُسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاههم، بالتوازي مع تطبيق القوانين الكفيلة بفتح أبواب العمل أمامهم في القطاعين العام والخاص.
لم يعد ملف متلازمة داون في سوريا يحتمل المزيد من التسويف أو الاعتماد على الاجتهادات الفردية. فبين طفولة بلا دمج، وشباب بلا عمل، تقف الأسر وحدها على خطوط المواجهة. وهو ما يحتم على صنّاع القرار في الإدارة الجديدة أن يمنحوا هذا الملف ما يستحقه من اهتمام، ليس باعتباره مبادرة إنسانية فقط، بل باعتباره «حقاً قانونياً» ينبغي ترجمته إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع. والخطوة الأولى تبدأ بالاعتراف: أن الكروموسوم الزائد لا ينتقص من حق الإنسان في الكرامة، أو التعليم، أو العمل.
كتابة: محاسن عبد الحي
يُنشر هذا التقرير في إطار تعاونٍ بين «صوت سوري» و«عكّازة»